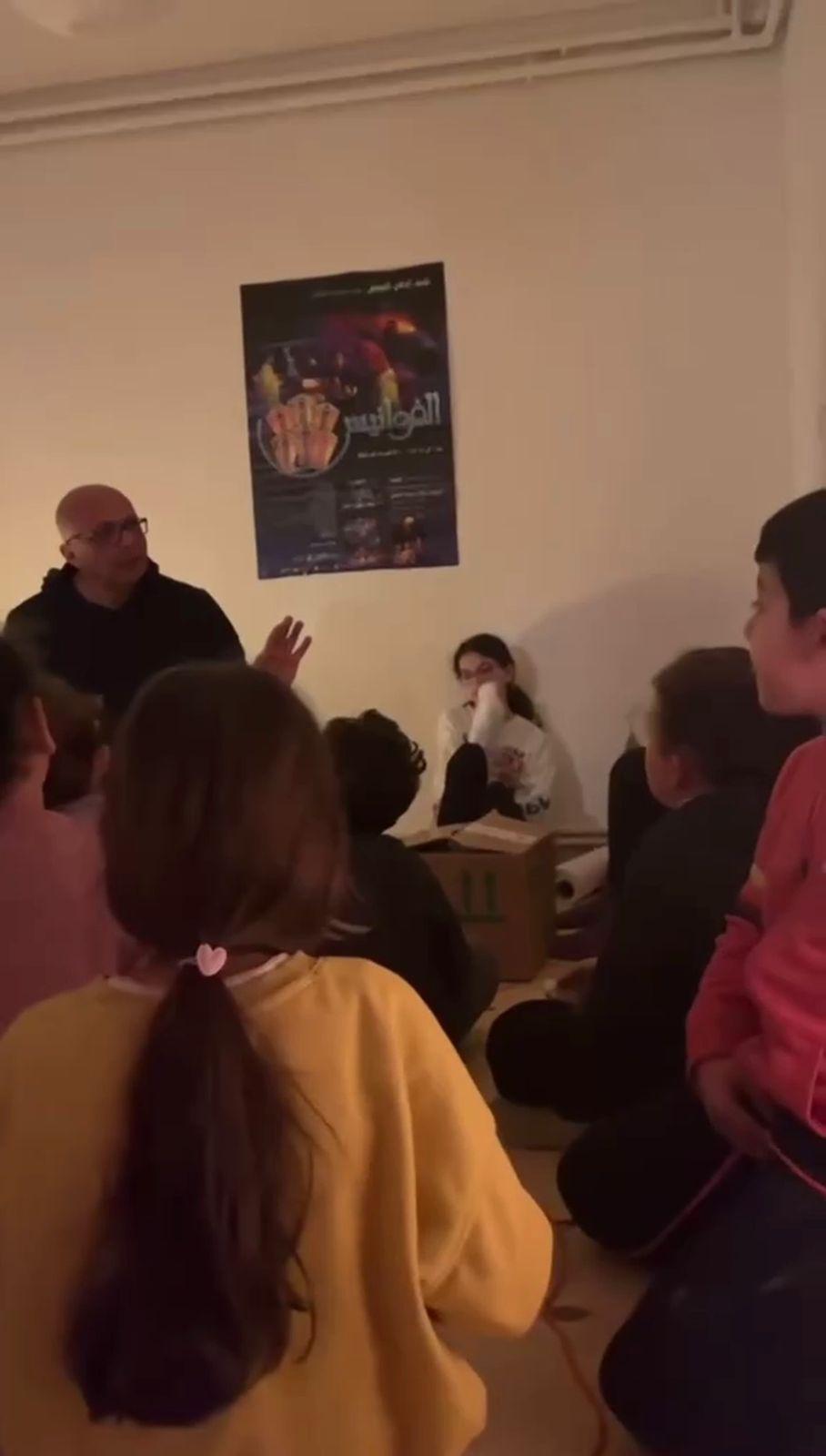قدمت هذه المداخلة في مؤتمر المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" 2024
(1)
"وسَألَ وسُئِلَ واعترضَ وأجاب" هذا اقتباس مستل من متن حديث أطول لتاج الدين السبكي في كتابه "معيد النعم ومبيد النقم" عن "المُدرِّس"، ويقول فيه: "ومن أقبح المنكرات مُدرِّسٌ يحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب، ويجلس يلقيها ثم ينهض، فهذا إن كان لا يقدر إلا على هذا القدر فهو غير صالح للتدريس... فَقَلّ أن يوجد عاميّ لا يقدر على حفظ سطرين. ولو أن أهل العلم صانوه، وأعطى المدرس منهم التدريس حقه لجلس، وألقى جملة صالحة من العلم، وتكلم عليها كلام محقق عارف، وسأل وسُئِلَ، واعتُرضَ وأجاب وأطال وأطنب... ." (النجار والزريني، 1985 : 79، 80) إذن، فليس دور المعلم تلقين التلاميذ ما يحفظ بل إن دوره يقوم على "طرح الأسئلة" والبحث عن إجابات، بل أكثر من ذلك، فإن له دور الاعتراض والتفاعل معه بما يعنيه ذلك من حوار يقوم على تعدد المنظورات ووجهات النظر، وهذا التعلم الذي يقوم على التساؤل والاختلاف تعلم يؤسس لمنهجيات "الحوار". فالحوار هو جوهر التعلم.، ولكنه الحوار الذي يقوم على الامتزاج العضوي بين العملي والفكري والتأملي معًا والذي يسميه باولو فريري " praxis /براكسس" حيث لا يكفي اجتماع البشر في حوار من أجل اكتساب المعرفة المتعلقة بالواقع الاجتماعي الذي يحيون فيه، بل عبر تفكير حواري نقدي في هذا الواقع من أجل تغييره عبر مزيد من الامتزاج بين العملي والنظري الذي يسهم في تغيير المنظور الاجتماعي وبالتالي إحداث تغيير ما فيه. إنما الحوار هنا بمعنى من معانيه الكبرى تجسيد "التطبيق العملي" لأنه ليس كلاما وحسب بل هو أفعال أيضًا. وهذا التطبيق يحتاج إلى الفكرة ويدها معًا. (Freire, 1972)
وهنا يتجاوز مفهوم "الحوار" الجدال، بل يتأسس على إعادة إنتاج علاقات القوة بين المتعلمين والمعلمين على السواء بحيث يمكن للمعلم أن يشتغل على إعادة توزيع السلطة بينه وبين المتعلمين، وبطبيعة الحال فإن علاقات القوة هذه لا يمكن إلغاؤها، ولا ينبغي ذلك لأن الحوار يقوم أساسًا على علاقات قوة تنتج خطابات مختلفة، وهذا الاشتباك يقع على تخومها، وهو الذي يشكل فاعلية إنتاج المعرفة.
إن فعلا من هذا النوع يمكن له أن يسهم في "تحرير التعبير" مما يَعْلَقُ به من موروث أحادي الصوت، بل مما يحكمه من صوت أحادي راهني يجافي تعددية الأصوات التي يمكن لها أن تتخلق عبر الحوار.
(2)
يعبر "التعليم" عن السائد الاجتماعي في أحسن أحواله أن لم يكن أغليها، يمكن لبعض الاختراقات أن تتجاوز هذا السائد الاجتماعي المألوف غير أن التعليم في المحصلة النهائية هو منظومة "مترابطة" و "حصينة" وتستمرىء العادي والمألوف والمستهلك، وتتماهى مع النظام السياسي والاجتماعي كمرآة له. وبالتالي، فإن تعبيره عن التحولات الاجتماعية أو محاولتها يغدو ضئيلا واستثنائيا.
(3)
في فلسطين لدينا حالة مركبة، لا تقتصر على الاجتماعي/ السياسي في سياق تاريخي "طبيعي" في تعريف النظام التربوي ووصفه وتحليله واختراقه أيضا بل على تأثير هائل ومباشر ونوعي بسبب احتلال استعماري مستمر، على مدى قرن ويزيد، وبالتعاضد مع قوى الاستعمار الكبرى، في الإبادة والإحلال، وبالتالي تقويض كل ممكنات النهوض، وعدم السماح للشعب الفلسطيني في أنْ يحقق شيئًا ما طموحاته، وأنْ يفقد الأمل.
ولعلَّ حرب الإبادة التي تحدث في غزة هذه الأيام، وحرب الاستيلاء على الأرض وإرعاب الناس في الضفة تشتغلان معًا لتحقيق غابات الاحتلال الكبرى. وفي هذا السياق، ينبغي علينا كشعب فلسطيني مواجهة ذلك، ليس عبر التمسك بالمنظومة التربوية الراهنة، بل عبر تقويض مفهومنا للتعليم ودور المدرسة. إن الإبادة الشاملة بما فيها تقويض المنظومة التربوية في قطاه غزة ينبغي أن تشكل "فرصة" لا يكون طموحها "استعادة" المنظومة التربوية التي كانت قائمة في القطاع قبل تدميره ولا زالت قائمة في الضفة، بل أن يكون طموحها أنْ تعيد تعريف "المدرسة" ودورها في سياق تاريخي متكامل تلعب جميع مكوناته المجتمعية دورها في ذلك. إننا أمام واقع يتطلب منا البحث "وجوديا" عن فعل اجتماعي تراكمي يسهم في الصمود وفي التقدم أيضًا. إن دروسا كثيرة ينبغي تعلمها من الماضي، تسمح لنا بالبحث، إبداعيًا، عن عناصر القوة التي لا تضمن وجودنا فقط، بل تنشد حريتنا أيضًا.
وينبغي علينا ألا ننجر وراء ما يروج له هذه الأيام من ضرورة "إصلاح التعليم" الذي ظهرت وثيقة له مؤخرًا ينبغي التحقق منها وهي عبارة عن اتفاق بين "السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي" على الشروع في هذا الإصلاح الذي يراد لنا لا ذلك الإصلاح الذي نريده نحن، ينبغي أن يكون الإصلاح لغايات تقوّي دور التعليم في المجتمع لا أن تحوّله إلى "ماكينة لإنتاج أفراد على مقاس الواقع السياسي الراهن واشتراطاته ومنهجيات الإخضاع فيه.
(4)
لعل المبالغة في التفاؤل ستفضي بنا إلى إنتاج اليأس؛ فالتجارب السابقة لا تشي بالكثير من التفاؤل، وبخاصة حينما تقوم محاولات التغيير عبر مظلة السلطة السياسية، ولدينا مثالان جليان على إجهاض محاولات التغيير، الأولى حينما أنشئ أول مركز مناهج فلسطيني بقيادة الدكتور إبراهيم أبو لغد، ونتج عنه خطة شاملة لمستقبل التعليم في فلسطين بعد تسلم السلطة الفلسطينية زمام وزارة التربية والتعليم إثر اتفاقية أوسلو وأجهضت الخطة بعد أن تمت تشظيتها، ولم ينظر إليها في صورتها الشاملة الكلية. والثانية حينما أُجهض تقرير تحسين المسيرة التعليمية الذي أنجزته لجنة خاصة شكلها رئيس الوزراء في حينه "رامي الله الحمد الله" في العام 2015 وحُبسَ في الجارور.
(5)
إن "التحرر" بمكونه الاجتماعي والسياسي وبجميع عناصر كل منهما ينبغي أن يرى كعملية متداخلة لا تفصل أبدًا بين المكونين، ولا تراهما مجزئين، إن الفصل بينهما على مدى العقود الأخيرة الماضية كان وبالا على الفلسطينيين وبديا كفعلين منبتي الصلة عن بعضهما البعض. وقد ألقى ذلك بثقله على كل مناحي الحياة بما فيها المنظومة التعليمية.
(6)
إن محاولة إنشاء نظام تربوي "طبيعي" يشابه، بل يماثل أنظمة التعليم في الدول المجاورة أو يقتضي بتجارب عالمية دون الالتفات إلى خصوصية السياق التاريخي أدى إلى انعزال "المدرسة عن مجتمعها" كفاعلة نقدية وترسخت كصورة مجسدة للنظام الاجتماعي الراهن. وبالتالي، فإن الارتهان للنظام التربوي القائم لإنجاز مهمة تغيير هي ضد طبيعته أصلا سيبدو وهمًا مركبًا؛ "وهم السيادة ووهم التحول".
(7)
دائمًا يجري الحديث عن المعلم باعتباره الركيزة الأساسية للتغيير، وننسى بأن المعلم تاريخيا لم يستطع، إنجاز مهمة من هذه النوع، في الغالب.
إن معظم المعلمين ينخرطون في عملية "تعليم" لا يُفَكَّرُ فيها كثيرًا، وهي ذات طبيعة إجرائية ومكررة ومستنسخة، ومستعارة، وغير نقدية. وفي أغلب الأحوال؛ فإن البرامج الأكاديمية لا تحفز على ذلك كما أن برامج التدريب النوعية، على ندرتها، التي يمر بها المعلمون تجابه "بقيم مجتمعية دفاعية، و"برؤية موجهة للمنهاج" و" بالأيدولوجيات السائدة". إن النماذج القليلة من المعلمين التي اشتغلت وتشتغل على إحداث تغيير نوعي في دورها التربوي والاجتماعي محدودة وبقيت أسيرة أطر ضيقة ومحددة، ولم تتمكن من التحول إلى قوة مجتمعية مؤثرة على المنظومة التربوية بمجملها. إن أي تغيير تبدأ شرارته من مبادرة هناك أو هناك تقتضي أن تتحول، مجتمعيا، إلى قوة اجتماعية قادرة على إحداث اختراقات تسهم في تغيير حقيقي وفعال ومتواصل.
حين يتحول المعلم إلى فاعل اجتماعي أو بمعنى آخر إلى "معلم عضوي" يمكنه إدراك تصورات المجتمع التربوي وحاجاته ضمن رؤية واقعية وتفسير نافذ ذي طبيعة نقدية ويعمل من أجل تحقيق هذه الحاجات وتلك التصورات. ويتجاوز دوره "الصفي" إلى دوره الاجتماعي، هنا يمكن للجدران التي تفصل المدرسة عن سياقها الاجتماعي أن تقوض، وتصبح المدرسة أكثر حضورا في مجتمعها ويغدو المجتمع أشد حضورا في مدرسته. وإذ نشتق تعبير "المعلم العضوي" فإننا نشتقه من مصطلح "المثقف العضوي" عند غرامشي. وبالتالي يمكن للمعلم أن ينخرط مع مجتمعه ومصالحه الحقيقية ويمكن له أن يكون ضدها، إن موقعه وحده لا يقرر دوره، بل أن فعله في موقعه هو الذي يبني دوره. وبالتالي يمكن للمعلم أن يلعب دورًا مهمًا مع الطلاب الذي يمتلكون القوة الكامنة من أجل التغيير. (2019 Morais, Melo Junior & Domingues)
وبدلا من أن يلعب المعلم دورًا "وعظيًّا" كما يحدث تاريخيا في كثير من الأحوال، فإنه سيلعب دورًا اجتماعيا حيويًا كفرد في جماعة يشكل تصوراته وأفعاله عبر عمليات تاريخية مرتبطة بالجماعة، وهي أفعال في جوهرها أفعال حرية، يتم عبرها صياغة تصور جديد للمجتمع من المجتمع نفسه وتجديد التصور طوال الوقت حيث لا يستقر على صورة ثابتة بل صور تتبدل وتتغير معبرة عن فعل اجتماعي حيوي، يسهم في تحقيق واقع ملموس يتجسد على شكل أنظمة سياسية وثقافية واجتماعية متوافقة مع إرادة الناس في الحرية والانعتاق، وهذا لا يتحقق دون تكوين وعي نقدي يمتد من المدرسة إلى مجتمعها ومن المجتمع إلى مدرسته.
(8)
إن التعلم فعل ثقافي اجتماعي سياسي قيمي، وبهذا المعنى فهو محكوم بسلاسل من المنظورات والمصالح والمحددات، ودون رؤيته في علاقته الفاعلة بهذه السلاسل، فإنه سيبقى معزولًا ومنعزلا عن إحداث تأثير نوعي وسيعيد إنتاج ما كان ينتجه وما بقي ينتجه حتى اللحظة.
(9)
وفي ضوء ما تقدم ينبغي علينا؛ أولا- البحث في صيغ اجتماعية تخلق قوة مجتمعية قادرة على الانتقال بالمبادرات التربوية الحيوية المتقدمة من أطرها الضيقة إلى فضاء أوسع. وثانيا - الحاجة إلى مبادرة مجتمعية تعمل على إقامة مجلس أعلى للتعليم له صلاحيات على مستوى وطني ويشمل جميع الفلسطينيين أينما كانوا، ويمكن له أن يرنو، بتضفير منظورات متعددة، إلى صوغ رؤى وسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعليم الفلسطينيين أينما كانوا وفي إطار سياقاتهم المتعددة وروحهم المشتركة، بحيث يسهم هذا التعليم في تكوين الغايات الكبرى المشتركة للشعب الفلسطيني، ودون ذلك سيبقى التشظي هو العلامة الفارقة ليس للتعليم وحده، بل لجميع مناحي حياتنا. فالتغيير لا يقوم على الأفكار الجميلة الراهنة وحسب، بل إلى قوة تحملها إلى مستقبلها.
المراجع:
النجار والزريني (1985) الفكر التربوي عند العرب، الدار التونسية للنشر. تونس
Freire, P. (1972). Pedagogy of the oppressed. Penguin.
Morais, Melo Junior & Domingues (2019) THE ROLE OF THE TEACHER AS AN ORGANIC INTELLECTUAL IN THE LIGHT OF GRAMSCI. Revista on line de Política e Gestão Educacional,
vol. 23, no. 1, 2019, January-April, pp. 147-159
***